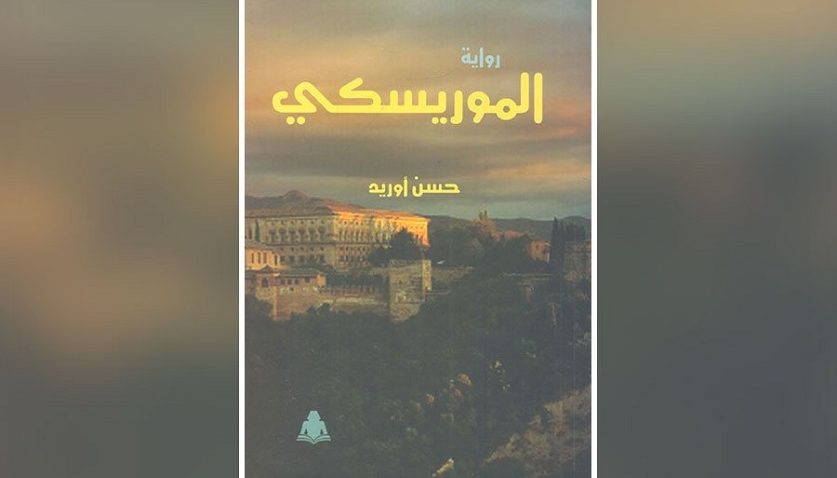في رواية “الموريسكي” للكاتب المغربي حسن أوريد يشعر القارئ أن هناك هدفا أيديولوجيا وفكريا تم التخطيط له بشكل فني لافت من البداية، يتمثل هذا الهدف في كون الغاية الكبرى من الأديان واحدة على اختلاف الأسماء والمظاهر والشعائر الخاصة بكل دين من الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام.
في حدود هذا الهدف يتحول التاريخ أو العودة إلى التاريخ إلى عودة نفعية في الأساس، فالتاريخ بالرغم من هيمنته وحضوره الكثيف في الرواية إلا أن الهدف مشدود إلى تجليات آنية أهمها مساءلة الحالة الراهنة، ومحاولة تبرير الوصول إلى حال التوزع والتناحر بسبب الانتماءات العديدة، وكذلك تبرير السلوك الحاد، والإشارة إلى ارتباطه بالماضي الممتد إلى اللحظة الراهنة. تفترض الرواية أن هذا الأثر سيظل موجودا ما لم يوجد نوع من التسامي أو الغفران الذي يجمع كل هذه الاختلافات التكوينية للوصول إلى وحدة تضم أشتاتا متباينة.
فالرواية المشدودة إلى مرجع تاريخي ترتكز إليه يتمثل في كتاب أفوقاي “ناصر الدين على القوم الكافرين”، تحاول أن تقدم- كما يقول مؤلف الرواية- تجليا مغايرا لقصة أبي الحسن الوزان، ولكن بالمقلوب، على أساس أن الحسن الوزان أنهى حياته مسيحيا في بلاط البابا، وأن شهاب الدين الشخصية المركزية أنهى حياته في بلاد الإسلام. وحين تستند الرواية إلى مرجع تاريخي تشير في السياق ذاته إلى إدراك صاحبها لرواية أمين معلوف “ليون الأفريقي” صاحب الأيديولوجيات القاتلة. رواية معلوف تشير فنيا إلى نتائج الأيديولوجيات المتناحرة وإلى أثرها السلبي، وتحاول أن تفكك هذا الأثر لتلقي أو لفهم الأديان بوصفها أطرا للتمايز والاختلاف، وتعمل على إحلال وتجذير مكانها هوية إنسانية لا ترتبط بعرق أو دين.
تستند الرواية إلى فن السيرة وكتابتها، ولكنها في كتابتها لسيرة البطل منذ ولادته في إسبانيا وهجرته إلى المغرب حتى وفاته بتونس خوفا على حياته ودينه من محاكم التفتيش، تشكل عالما واسعا، وتقارب موضوعات على نحو كبير من الأهمية، منها مسألة الهوية، وأسسها الحقيقية، وأسسها الزائفة التي لا تقف كثيرا أمام المناقشة والمقاربة.
مقاربة موضوع مثل موضوع الهوية في هذه الرواية يتطلب وعيا بالاختلافات الحادة التي كشفت عنها الرواية، ووعيا بالصعوبات التي مر بها هؤلاء الموربسكيون في الماضي البعيد، لأن هذه الصعوبات تركت أثرا لا يمحى، إن نظرة فاحصة إلى المنجز الروائي بدول المغرب العربي تكشف عن أن العودة إلى التاريخ لمقاربة الماضي بكل تجلياته تشكل وجودا لافتا، وهذا يشير في الأساس إلى أن هناك إشكاليات في الوصول إلى تشكيل هوية تتساوق مع هذا التاريخ بأحداثه المربكة، وشرائحه التكوينية العديدة التي لا تزال مؤثرة وحاضرة وفاعلة، فحين يقول حسن أوريد في روايته “الموريسكي” على لسان والد السارد الفعلي في النص: “إنهم مثلما قلت لك آنفا يا بنيّ كالشجرة المنزوعة الجذور لا تنثني للريح والتي هي بلا نسيج، ولا تستفيد من مؤثرات الطبيعة، ولا يمكنها أن تستفيد من مفعول المطر. هكذا صرنا في معظمنا أشجارا ميتة، ولهذا السبب أصبحنا عنيدين صعبي المراس، لأننا أضحينا مجتثي الجذور”، ندرك أن هناك تماهيا بين صوت السارد وصوت المؤلف، في الكشف عن الآثار السلبية للماضي وأحداثه البعيدة التي شكلت تلك الهوية البشرية.
إن هذه الأحداث الموحشة أو المأساة التي مرّ بها الموريسكيون بفعل محاكم التفتيش، وطردهم من ديارهم التي كان لها تأثير في تشكيل طبيعتهم الصلبة غير المرنة بوصفهم أناسا منزوعي الجذور، يعيشون أو يوضعون في سياق مغاير كانت ذات أثر خاص في جانب آخر مثل الإيمان بالشعوذة التي أشار إليها النص الروائي، في قوله “كنا نراقب الإشارات، لكي نغالب آلامنا وأحزاننا، وقد لزمني الكثير من الوقت لأتحرر من هذا الانقياد الأعمى لهذه الأفكار البالية”.
وطبيعة الموريسكيين التي تجلت في الاقتباسين السابقين على نحو كاشف يزيد من حدتها ذلك التعدد الذي يدركه قارئ الرواية لمجموعة الشرائح البشرية، حيث تتجلى أمامه أنماط أيديولوجية مختلفة الجذور والاهتمامات والانتماءات. فأنتاني الذي حمل رؤية فلسفية للدين، ولديه مسافة نقدية تجاهه ويتميز بخصال إنسانية أمازيغي، والشاوي الذي قدمت صفات ترتبط بالتملق عربي، والفشتالي عربي أصولي متشدد، بالإضافة إلى جنسيات عديدة كان لها تأثير في تشكيل الكون الروائي، وتجليه على نحو خاص بأطره المعرفية التي بدأ في تحديدها وتشكيلها مبكرا.
هوية الوطن والمكان في مقابل الأديان
ربما كانت الجزئية الأساسية التي اشتغلت عليها الرواية في بنائها – وأصبحت أساس المكونات الفكرية الأخرى – تنطلق من طبيعة الشخصية التي تؤسس الرواية سيرتها وتقاربها وفق لحظة آنية منفتحة على الحاضر والمستقبل أكثر من ارتباطها بالماضي وإن كانت تنطلق منه، وتتشكل وفق محدداته، وأمراضه المزمنة التي تلازمها على الدوام. فالشخصية الرئيسة عانت من ويلات الاضطهاد الديني والتهجير على أساس الانتماء الديني، وعلى أساس الرائحة التي يشمها المباين في الآخر.
وقد تجلى ذلك واضحا في مجموعة من الممارسات التي مورست ضده، وضد الموريسكيين، سواء في الأندلس أو في المغرب.
فإذا كان الاسم كاشفا عن هوية الشخص فإن الشخصية الرئيسة- وأفراد العائلة أيضا- تعرضت للمحو مرتين، مرة في الأندلس تحت تأثير هزيمة المسلمين ومحاولات الطمس والتحويل، فقد غيّر المسيحيون بقوة الوجود والسلطة والقدرة على تشكيل الآخر اسمه من أحمد إلى بيدرو، وغيّر الحاكم المغربي بعد هروبه إليها اسمه إلى شهاب الدين، وهذا يبرّر قلق الشخصية وتوزعها على مدى صفحات الرواية، ويبرّر تبعا لذلك قلق الهوية الذي لا يزال فاعلا، ومحل تفكير ودراسة ومساءلة، فقد حمل هؤلاء أوطانهم داخلهم وحاولوا أن يقيموا عالما على غرار حياتهم السابقة في السلوك وطريقة بناء منازلهم، ولكن ذلك لم يكن شيئا سهلا.
وفي ظل هذا القلق الخاص أصبح التوجه الأساسي في الرواية يرتبط بتأصيل منحى فكري مشدود إلى النظرة الفلسفية للأديان، نظرة ترتبط بالغاية بعيدا عن اختلاف الطقوس والمظاهر والشعائر التي ربما تشكل بابا للتباين والاختلاف المؤدي إلى الصراع، انطلاقا من فكرة أساسية لدى أصحاب كل ديانة على حدة، فأساس الصراع بين الأديان قائم على جزئية احتواء الدين على الحقيقة، فيصبح الدين- والحال تلك لدى أصحابه- الدين الحق، وكل ما يقابله من أديان ومعتقدات يعتوره النقصان.
وفي بناء هذا التوجه الفكري تتوسل الرواية بمنطلقات محددة، تجلت بشكل لافت للنظر، بآليات مختلفة، وعلى لسان أبطال عديدين مما يجعلها فكرة محورية. يتمثل المنطلق الأول في النقد الواضح لرجال الدين الذين يؤمنون بالمغايرة والاختلاف والتميز أو الحقيقة الناصعة التي يملكها الدين الذي ينتمون إليه دون الأديان الأخرى. ففي منطق الرواية هناك دور سلبي لرجال الدين في تزكية الصراع بين الأديان، وفي تأجيج مشاعر العداء، كما قدمت في حديثها عن الخوري (ميكو) حين خطب في الكنيسة، وتحدّث عن العقيدة المسيحية الحق، قائلا (هل علينا أن نقبل بأن تفسد هذه الجرثومة (يقصد المسلمين الذين تنصروا ظاهرا) العقيدة الحق بجملة من الممارسات المحمدية والوثنية والمسيحية، أم علينا أن نصمم على الدفاع عن الإيمان الخالص، إيمان أسلافنا؟
إن فكرة الدين الحق القائمة على التميز والاستعلاء هي طريقة هؤلاء المنتمين إلى رجال الدين في كل الأديان، لتأصيل الخوف لدى جماعتهم للبعد عن الآخر والإنصات إليه والحوار معه، لأن هؤلاء في منطق النص الروائي يبحثون عن صفاء العقيدة المشدود إلى التوجه الأحادي المنطوي على ذاته، ومن ثم حين توزع الرأي حول وضع الموريسكيين بين رجال الدين ورجال الاقتصاد والمال وأصحاب الأملاك في إسبانيا تم الانتصار لرأيهم. فقد كان رجال المال يرون أن دور الموريسكيين حيوي ويستوجب بقاءهم، ولكن رجال الدين بحثا عن صفاء العقيدة الأحادية التي تملك اليقين الناصع يرون رأيا مغايرا يرتبط بالخلاص منهم بالقتل أو التهجير إلى الضفة الأخرى، ومن ثم يستجيب أهل البلاط والساسة لرأيهم، لأنهم يدركون أن وجودهم حكّاما يرتبط بنصرة رجال الدين، ووقوفهم خلفهم، فالحاكم في ذلك السياق يقدم نفسه- مسلما أو مسيحيا أو يهوديا- بوصفه حارس العقيدة، وحاكما باسم الرب، ومنفذا لتعاليم الدين.
التوجه الثاني الذي تتوسل به الرواية لبناء هذا الإطار الفكري يتمثل في وجود إشارات في نص الرواية تبدأ بسيطة على لسان والد السارد، حين يقول: “الطريق الوحيدة لاعتناق دين ما هي إلا المحبة والعدالة”. بعد ذلك تتعدد الإشارات وعلى لسان شخصيات عديدة للوصول إلى المعنى الفلسفي أو النظرة الفلسفية إلى الدين في الأجزاء الأولى من الرواية، قبل أن يتمّ الاشتغال عليها بشكل مكثف في الأجزاء الأخيرة بفعل الرحلة والحوار مع الآخر، وكأنها نتيجة مبنية على تجرية معيشة ممتدة، ولكن الوصول إلى هذه النتيجة ما كان له أن يتمّ دون الوعي المتسرب بشكل جزئي في أصوات الشخصيات الأخرى.
ربما كانت الإشارة الثانية مرتبطة بحديث شقيقة السارد الصغرى سارة في ظل سيادة الوجود الإسلامي، أو إيناس في ظل هيمنة الوجود المسيحي، حيث لم تتحمل الاستمرار في الحياة بين هويتين أو حياتين ظاهرة وباطنة، فتصل في النهاية إلى أن الإله الذي يعبده المسلمون والمسيحيون واحد، وكل فريق منهما يعبده بشكل مختلف. وهذا المعنى ظهرت بوادره للسارد الفعلي في النص لحظة الدفن بعد وفاتها مقتولة، ولكن وجوده لم يستمر على نحو ملموس، لأنه كان متأثرا بوجهة نظره تجاه المسيحية، ونظرته الأحادية لمشروعية تفوق الدين الإسلامي، تقول الرواية على لسان بيدرو السارد الفعلي في النص: “يا ليتها بقيت حية، ولتكن مسلمة أو مسيحية أو يهودية، فالحياة تعلو على كل شيء”.
وتتناثر إشارات عديدة في ذلك الجانب مرتبطة بأناس كانوا مسلمين اسما، ولكنهم لم يكونوا يقومون بالشعائر الإسلامية، فهناك شخصيات عديدة في الرواية لا يعرفون عن الإسلام إلا نتفا، وعلاقتهم باللغة العربية ضعيفة، يشربون الخمر، ويواقعون النساء، مثل بلانكو، ورودريجيز، وبالامينو، وتقدمهم الرواية بوصفهم ضحايا الانتماء إلى الإسلام، فقد وقع عليهم الطرد والتهجير، بالرغم من كونهم ليسوا مسلمين ملتزمين، وليسوا عربا، فرودريجيز يقول بدون مواربة إنه لا يعتبر نفسه مسلما أو مسيحيا، والآخران ينسيان الوضوء.
وبأخذ هذا التوجه الثاني بعد هذه الإشارات مدى أوسع، حيث تقدم الرواية وجهة نظر منسوبة إلى (دوغا)، فهو يرى أن الأديان السماوية الثلاثة على تنوعها تمثل حجرا على الإنسان، يقول دوغا مخاطبا شهاب الدين/ أحمد/ بيدرو (بالنسبة لي لا فرق بين الإسلام والمسيحية واليهودية، فهي كلها حجر على الإنسان).
وبعد تفتيت مشروعية الانتماء الديني المغلق بتعاليه من خلال إشارات جزئية مبثوثة على ألسنة الشخصيات في نص الرواية تصل الرواية إلى توليد بديل، يمكن أن يكون صالحا لبناء إطار عام يجمع الأشتات المتباينة، وهذا الإطار لا علاقة له بالأديان، وإنما يرتبط بفكرة الوطن أو المواطنة أو المكان حيث يؤسس له في النص الروائي بوصفه إطارا يجمع أصحاب الديانات المختلفة، طالما أن النظرة الفلسفية إلى الأديان تشير في النهاية إلى مجموعة من القيم والأخلاقيات، يتم الوصول إليها من خلال مظاهر وشعائر مختلفة مع كل دين. فبلامينو في ذلك الإطار لم يكن مسلما ولا مسيحيا، فقد كان يحب السمر، ويحب الخمر. والسمر في منطق الرواية فعل أدائي ثقافي خاص بالمكان، وبأهله من الأندلس، دو أدنى علاقة بالأديان.
إن الرواية حين تؤسس لفاعلية المكان/ الوطن في تشكيل الهوية تنطلق في الأساس من الحالة الحضارية المرتبطة بالسياق الزمني للرواية، وتشير إلى أن غياب ذلك التصور لحظة المرور بالتجربة كان السبب الأساس في تغوّل محاكم التفتيش، وفي وجود هذا التعامل غير الأخلاقي وغير الإنساني مع الموريسكيين. يؤيد ذلك قول خايمي رفيق السارد الفعلي في هروبه من الأندلس: “ولكنني لست مسلما يا بيدرو، إنني لا أعرف من أكون في واقع الأمر”، وفي ذات الصفحة يشير إلى حبه للأندلس مكملا وجهة نظره واستراتيجيته في اعتبار المكان/ الوطن بديلا ناجعا لفكرة الدين، حيث تتولد له هالة وقدرة على جمع الأشتات المتباينة، ويوجد وحدة جامعة لهذا التعدد.
أفق الرحلة والحوار
الهوية الدينية في الرواية تصبح ذات نتائج سلبية إذا كانت منطوية على ذاتها، لا تبصر سوى حدودها، وليس لدى أصحابها المتجذرين بها قدرة على إبصار ما لدى الآخر المباين من إيجابيات، لأن سيطرة أو فاعلية التنميط الذهني يمارس دوره في تشكيل الذات من خلال تسكينها في أفق أعلى، وقولبة الآخر في إطار جاهز يرتبط بالرؤية الإجمالية المشدودة والمبنية على صراع طويل وحوادث لا تمحى من الذاكرة. ولا يفرق أصحاب تلك الهوية بين من قاموا بالفعل وشاركوا في هذه الحوادث في أزمنة متباينة وغيرهم من الذين ينتمون إلى هذا الدين، لأن هذا الانتماء المشدود إلى رؤية اصطفائية للدين وكأنه حقيقة مطلقة يشكل هوية دينية مغلقة تمنع إبصار الآخر وقيمته.
إن نظرة فاحصة إلى حركة البطل وإلى التجارب المريرة التي مرّ بها، بالإضافة إلى النموذج السابق الجاهز الممثل في والده وجدّه الذي يطل بوصفه قالبا، تثبت أن هناك حالة من حالات الصدام، فقد كان ينظر إلى المسيحية والمسيحيين بشكل عام كأنهما يشكلان إطارا جاهزا للعدو. وهذا كله تشكل وفق المعرفة النمطية المتبادلة القائمة على القولبة الجاهزة، دون أدنى توجه لمعاينة ومقاربة هذه الصورة وفق وجهة نظر مغايرة، أو محاولة الوقوف على عوار منطلقاتها.
ولكن هذا التعارض أو التصادم العنيف بين طريقين لا تلتقيان، تشكلان المسيحية والإسلام يتعرض لهزات، ويبدأ في التعرض للمساءلة وإعادة المقاربة والمعاينة أثناء سفره ورحلته إلى أوربا. ففي رحلته إلى أوربا، وفي عمل أقرب إلى عمل السفير في التحديد الراهن لعرض مسألة وموضوع الموريسكيين لدى الأمم الأوربية، ومحاولة استرداد أموالهم تتم مراجعة مفهوم الآخر لديه.
تبدأ المراجعة من خلال ظهور الشك في الصورة النمطية المعهودة عن الآخر، وذلك من خلال عقد لقاءات فكرية وحوارات مع شخصيات من جنسيات فرنسية وهولندية. ولكن التجربة الأكثر فاعلية في ولادة فكرة المراجعة أو الشك في النمط الجاهز الذي يسدله أصحاب كل دين على الآخرين تتمثل في لقائه بالفتاة الفرنسية أوجيني التي يقول حسن أوريد عن دورها الكبير في طبيعة تحوّل الشخصية الرئيسة في الرواية (الشخصية الرئيسة في الرواية شهاب الدين تكتشف في بلاد الإفرنج أن هناك شيئا أبعد وأعمق من الدين المسيحي الذي كان له تصور عام وخاص عنه. لقد اكتشف في علاقته مع الفتاة المسحية أوجيني البعد الإنساني نفسه، واهتز كيانه).
الرحلة ولقاء الآخر ليست في التحليل الأخير سوى انفتاح وعيين للوصول إلى وعي مشترك، وهذا يقلّم ويحوّر في كل وعي على حدة مما يجعله يتجلى في شكل جديد ناتج عن عملية الامتصاص والحوار. فلقاء البطل الرئيس بشخصيات فكرية أوروبية يشير إلى أن الأمور ليست بذلك التحديد الصارم الذي يولده رجال الدين في عنايته بالنقاء والنصاعة في تشكيل العقيدة، فيبدأ في معاينة الآخر وفق توجه جديد، فلم يعد معنيا بوصفه رجل دين بدحض وتفكيك أسس الديانة المسيحية، تقول الرواية على لسانه: “أي قدر هو قدري! هربت من العقيدة المسيحية ومن يتصرفون باسمها، وآليت على نفسي أن أقوم بمهمة دحضها. وطنت نفسي على أن أقوم بالدفاع عن الإسلام وتعاليمه. وها هي أوجيني تزعزع كل الحجج التي أتسلح بها. صرت أتبين الفروق بين المسيحيين الذين لم أعد أدعوهم بالكفار، وصار لي موقف نقدي إزاء إخواني في الدين”.
تفتيت الصورة النمطية والثابتة والساكنة للآخر بالرغم من تنوع ممثليه، واختلاف مشاربهم، لا يتجلى في النص الروائي بشكل منفرد، وإنما يتجاوب معه معاينة الذات لنفسها، ومراجعة قصور الرؤية لديها، ومعاينة تحولاتها البطيئة، فيلمح القارئ وجودا للنقد الذاتي على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، فرؤية المجموع المباين في النص الروائي تفتح أفقها للتفريق بين انماط عديدة، فهم ليسوا نمطا واحدا، فمن قاموا بعملية نفيه وتهجيره لا يمكن أن يكونوا ممثلين لمجموع المسيحيين، ولا يمكن أن يجسدوا المسيحية.
ويمكن للقارئ حتى يعاين أفق التغيير الذي لحق بوعي البطل الرئيس في نص الرواية أن يقارن بين حال اللقاء الأول حين مدت إليه الفتاة يدها بالسلام، ووقف مذهولا لاعتقاده أن لمس المرأة من عمل الشيطان، وبين قوله بعد الاتكاء على الحب بالمفهوم الواسع التي تتفتت معه الضغائن والصور النموذجية الثابتة في معاينة الآخر، فتؤدي معاينة الآخر إلى معاينة الذات ومجموعها الذي تنتمي إليه، تقول الرواية كاشفة عن هذا المنحى: “في أرض الإسلام، ليس كل شيء جميلا، وفي أرض المسيحية ليس كل شيء خاطئا، فالنظرة تتأتى عن طريق العقل، ولكن العقل وحده لا يكفي. هناك المحبة، خصوصا محبة الآخر أو القريب لتتأتى معرفته، لا يمكننا أن نعرف من لا نحب”.
إن الاقباس السابق يؤسس في نهايته المدخل الحقيقي لمعرفة الآخر، فالسبيل الناجعة في ذلك تتمثل في الحب. فذلك الحب بمعناه الواسع يمكن الوصول إليه وتشكيله إذا تخلص الإنسان من سطوة رجال الدين الذين يتخيلون- ربما لإضفاء ذلك على أنفسهم- أن دينهم يملك الحقيقة المطلقة، سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أو يهودا. فرجال الدين لديهم تصور به الكثير من المثالية والتعالي، فالبطل الرئيس لأسباب عديدة تتعلق بسياقه الحضاري وانعطافاته الانتقالية تم تكوينه تكوينا خاصا يجعله لا يرى في الإسلام إلا كل حسناته، ولا يرى في المسيحية إلا كل مثالبها.
ولكن الانفتاح على الآخر يزحزح هذه اليقينيات، لأن هذا الانفتاح يشكل نافذة جديدة للرؤية، فتبدأ الذات في مراقبة نفسها، ومراقبة الآخر، ونتيجة لذلك تنتقل من وعي أحادي إلى وعي منفتح على التعدد في مقاربة الحياة. والتغيير الداخلي الذي يصيب الشخصية لا يتم بشكل قاطع، وإنما بشكل متدرج من الشك في مشروعية وقيمة التقابل كقسيمين قائمين على الصراع، إلى الإيمان بمشروعية وجدوى الشك في فتح نوافذ جديدة للضوء، إلى الانفتاح على الآخر وإدراكه ومعرفته دون تنميط مسبق.
حين يحدث الحوار بين القسيمين- أي قسيمين- دون سطوة من رؤية استباقية جاهزة، سوف توجد مناح للتأمل، والنظر إلى الدين نظرة فلسفية، ترتبط بغاية الأديان، وليس بمظاهرها أو شعائرها المتباينة. الفيصل في ظل هذا التصور يرتبط بغاية الأديان، وقد نلمس تصويرا لهذا المنحى من خلال شخصية من شخصيات الرواية، وهي شخصية أنتاني، حيث تجلت من البداية بشكل واع مدرك لهذا التنوع الذي يعد قانونا أساسيا للوجود.
إن رواية “الموريسكي” في الأساس تمثل دعوة للتعاظم على الخلافات، والاستناد إلى المكان أو إلى الوطن، حيث يمكن للجماعة التي تعيش فيه أن تشكل من خلاله إطارا له قدرة على جمع المتناقضات والتباينات المختلفة داخل وحدة خاصة بعيدا عن العرق والدين ملتحمة بالإنساني في مداه الرحب، المشدود للنسبي بعيدا عن التحديد الصارم للأشياء الذي تنتهجه الهويات الدينية المنغلقة، فحين تقول الرواية في جزء منها: “ينبغي لأركان العقيدة وشعائرها التي هي ملازمة لكل ديانة، أن يفضيا في النهاية إلى أخلاق، وبدون هذا لن يكون لأركان العقيدة ولا للشعائر من معنى. الأخلاق هي الميدان المشترك أو الميدان الذي تلتقي فيه كل المعتقدات”، وحين يطالع المتلقي الاقتباس الأخير يدرك أن هناك مقاربة للأديان تتصل بالغاية أو بالمعنى الفلسفي لها، وسوف يبرر بشيء من الراحة والهدوء تداخل خطاب الإسلام، وخطاب المسيحية في دعاء البطل الرئيس في نص الرواية للإشارة إلى تحولاته من الصراع إلى حالة من الوحدة بوصفها حلا يكفل الحوار والتناغم بعيدا عن الصراع والاختلاف.
حسن أوريد: “الموريسكي“
الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2017