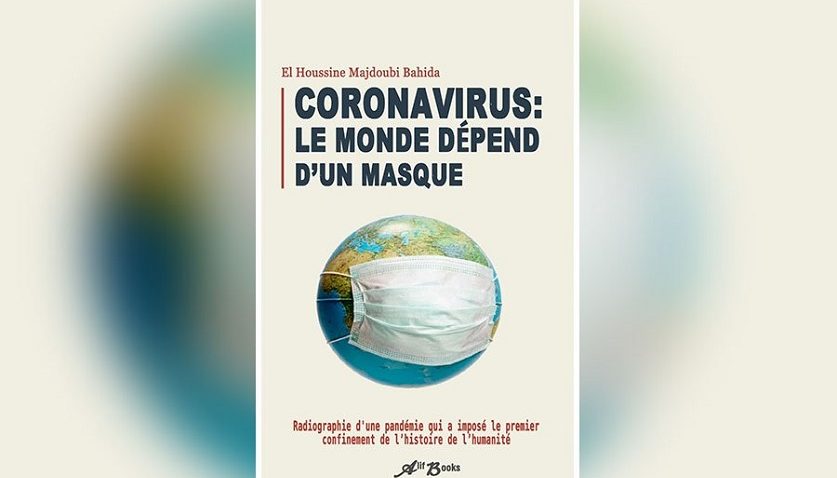“العالم رهينة الكمامة” هو العنوان الذي انتخبه الكاتب والإعلامي د.حسين مجدوبي لكتابه الجديد حول وباء فيروس كورونا. المؤشرات الحادة على التحول في حياتنا سلوكا وتفكيرا، أيقظ لدى الكاتب هذا التجاوب الفكري مع الوباء، وشده إلى جذوع الأسئلة الكبرى والاستراتيجية وأحيانا الملقاة في كل اتجاه أيضا، التي رَجَّعَتْ صَدى تقليب النظر فيها من قبل النخب الفكرية، ووسائل الإعلام بل وحتى المواطن العادي الذي وضعه قدر الاندهاش من فجائية الفيروس من جهة، وطوفان الاتصالي سواء أكان على مستوى وسائل الإعلام التقليدي أم على مستوى الشبكات الاجتماعية، وضعه في قلب النقاش المزدحم والفوضوي عن جائحة كوفيد-19.
لقد انبرى الكتاب الصادر باللغتين الإسبانية والفرنسية، يرتب محاور مضمونه وفق نسق هرمي للأسئلة الكبرى التي تساير في تطورها درجات تسلل الفيروس إلى انشغالاتنا اليومية، وخصوصا تلك الأسئلة الكثيفة التي شغلت الرأي العام الدولي، وتمحورت حول عجز البحث العلمي عن إيجاد لقاح للفيروس. أو تلك التي نفذت عميقا في حسابات جيوسياسية تقتفي خيط التغيرات الكونية الآخذة في التشكل، وتستشرف فجرا جديدا للإنسانية يكرس على نحو لافت الحتمية الرقمية ويُمْهِرُ نهاية حقبة المطبعة.
يفرد الكاتب مقدمة عمله لأسئلة الاستقبال الكبرى التي استقبل بها الرأي العام العالمي الوباء، وخصوصا تلك التي تعكس نزوعا نحو الاعتقادات السائدة حوله، ما يشبه القناعة بأن عهد الأوبئة قد انتهى، وانقضاء تلك المشاهد الصورية بالأبيض والأسود والتي علاها الصدأ كما هو حال صور الانفلونزا الإسبانية التي امتدت ما بين 1918 و1920 ليفاجأ من جديد بأزمة صحية من جنس أزمة الانفلونزا الإسبانية تعيث من جديد في العالم موتا ووباء، وتجثم على أنفاس الناس، وتعيدهم إلى زمن الأوبئة الأولى وإن كان هذه المرة في سياق كوني جديد، وفي عهد رقمي يظهر فيه الفيروس بصورة أكثر دقة وبصور ملونة، عكس الأزمات الوبائية السابقة. فهذا أول وباء يحل في العالم في العهد الرقمي.
تداعيات الجائحة الصحية الشرسة وآثارها التي غطت بشكل آني ومتزامن الكون، ثم الرد الإنساني والمتزامن، كشف معطيات تاريخية غير مسبوقة من أبرزها تنسيق كوني مباشر وغير مباشر في التعاطي مع الجائحة في زمن واحد، وقد اقتفى المؤلف آثار هذا الامتداد والتداعيات بوصف تحليلي صاغه في الفصل الأول المعنون بـ “حرب عالمية ثالثة غير منتظرة” وبلور في سؤال مشخص للتداعيات يتناول فيه وضع العالم وهو يتفاعل مع سؤال: “كيف فرض الفيروس على العالم حربا غير متوقعة؟” حيث حكم على الإنسانية جمعاء بأول حجر صحي في تاريخها. وتسبب في إغلاق الحدود بين الدول وفي تراجع التجارة العالمية، في وضع شبيه بما حدث في الحرب العالمية الثانية. يبدو هنا أن واجهات هذه الحرب يقف فيها الإنسان في جبهة مشتركة نسبيا وإن بهواجس وتباينات وإمكانات مختلفة، وضد عدو غير مرئي. إن هذا الاستنفار الإنساني ضد كوفيد-19 نابع بحسب المؤلف من قلق عارم لدى الإنسان المهووس بتأمين ذاته ومصالحه، وعلى لسانهم يتساءل الكاتب: كيف قتلت الأوبئة والفيروسات أساسا من بني الإنسان أكثر مما قتلت الحروب برمتها عبر التاريخ؟ في إشارة إلى مثلا الطاعون الأسود الذي أتى على أكثر من ثلث البشرية خلال القرن الرابع عشر. ويستعرض آراء العلماء وطروحاتهم حول نهاية البشرية على كوكب الأرض، ومن بينها نظرية فيروس قاتل تبقى هي الواردة، حيث إذا كان النيزك هو الذي قضى على الديناصورات، فالنيزك الذي يهدد الإنسانية سيكون هو الفيروس حسب ذات الطروحات.
ويتوقف في الفصل المعنون عند مقولة سادت بين خبر رصد الوباء وهو “المريض الصفر” وهو من يفترض فيه أول حامل للفيروس خلال نهاية كانون الأول/ديسمبر، حيث تضاربت الآراء الدولية حول مواطن من الصين متعارف عليه، ثم العثور لاحقا على معطيات أخرى حول أبحاث علمية تبرز وجود الفيروس في عدد من مناطق العالم ومنها إسبانيا وفي إيطاليا قبل هذا التاريخ. ومما يزيد في إشكال رصد “المريض الأول” هو الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وبكين حول التسبب في الفيروس مما عزز فكرة المؤامرة، علاوة على رأي بعض الباحثين مثل مونتنيي مكتشف فيروس السيدا الذي يتحدث عن تغيير في الحمض النووي للفيروس، لأهداف طبية خرجت عن السيطرة.
يقدم الكتاب مقارنة حول معركة السيطرة على الفيروس بين الصين التي نجحت في التغلب عليه رغم ظهوره في أراضيها، وبين معركة باقي العالم وأساسا الغرب الذين فشلوا في احتوائه. وينسب ذلك إلى تعاطي الصين مع الفيروس وكأنه حرب بيولوجية، ولهذا زجت بالجيش وخصوصا الطب العسكري لمواجهته، وساعدها أنها تعد مصنع العالم للمعدات الطبية علاوة على دور حاسم تقوم به وهو أنها تحمل مشروع زعامة العالم مستقبلا، ولهذا عملت كل مجهوداتها للانتصار على الفيروس حتى لا يتأثر مجتمعها واقتصادها.
ويطرح الكتاب إشكالا هاما تجسد في السؤال الآتي: من يمتلك سلطة القرار بشأن مكافحة الفيروس، هل السياسي أم العالِم؟ ويقدم شواهد على واقعة تغلب الإرادة الانتخابية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حينما رفض اتخاذ إجراءات احترازية استباقية رغم الوضع المقلق الذي كانت عليه أوروبا. ونتيجة هذا الإهمال تصدرت الولايات المتحدة نسبة الوفيات ونسبة المصابين في العالم. ويعتقد أن مسؤولية ترامب تتعدى السياسي إلى ما هو جنائي. ويؤكد ضرورة تولي لجنة علمية القرارات إبان الأوبئة بدل السياسي رغم أنه منتخب في الصناديق. ويشدد على الثقة في البحث العلمي، فالعلم هو الذي قاد الإنسانية من الكهوف إلى سبر أغوار الفضاء، وتوصل إلى أدوية قضت على مختلف الفيروسات.
وفي هذا السياق خصص الكاتب فصلا كاملا لموضوع العلماء بعنوان “في انتظار لويس باستور جديد” وفيه ينتقد من جهة هيمنة السياسي على العلمي إبان هذا الوباء، ومن جهة أخرى ينتقد إهمال الدول للبحث العلمي في الأوبئة وباقي الأمراض وترك ملف شائك في يد شركات الأدوية التي تعمل وفق أجندة ربحية. ويتساءل: هل يتعين على الدول أن ترهن حماية أمنها القومي بالشركات الخاصة حينما تفوت إليها هذا الأمر الطبي والصحي؟ ولما كان الشعب المكون من المواطنين هو أبرز من يتعين حمايته، فكيف يحصل أن تترك صحة الشعب في يد شركات أجنبية؟
ويعتمد الكتاب نظرة استشرافية من خلال رصد التأثيرات المقبلة، ويتجلى هذا في عناوين الفصول ومنها “الإنترنت ينقذ العالم من الإفلاس” وربط بشكل لافت بين أزمة الأوبئة وظهور آليات التواصل بعد كل وباء يضرب البشرية جمعاء، فيكون عنصرا من عناصر المواجهة للوباء نفسه مثلما حصل مع اختراع المطبعة بعد الطاعون الأسود، وكيف تتقدم العلوم بحثا عن حلول. ويكتب بأن الإنترنت تعود إلى التسعينيات، لكن تأريخها منعطفا في تاريخ البشرية هو محطة وباء كورونا فيروس، إذ تحولت إلى الآلية التي أمنّت وحافظت على النشاط البشري إبان الحجر الصحي الشامل. فمن جهة، حافظت على التجارة والعلاقات الدبلوماسية بين الدول والعمل عن بعد عموما، ومن جهة أخرى شكلت منصة عن بعد للتعليم الذي هو أساس الأمة. ويجزم بأن انتقال البشرية من مرحلة المطبعة إلى العالم الرقمي يجد تاريخه الحقيقي في هذا الوباء. وفي نقطة أخرى مرتبطة بالعالم الرقمي، يبرز د. مجدوبي وهو باحث أكاديمي في مجال علوم الإعلام، كيف ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي في تقوية شعور انتماء الشعوب إلى إنسانية واحدة، وهي تواجه هذا الفيروس رغم الاختلافات السياسية والإيديولوجية.
وفي تطور آخر، يقف مجدوبي عند الشرخ الذي سيتفاقم بين الدول الغنية والدول الفقيرة، ويستعرض الأرقام والمعطيات حول الطريقة التي ستنجح الدول الأولى بها في تجاوز الأزمة الاقتصادية بفضل الموارد المالية الهائلة التي خصصتها للاستثمار وتعويض المواطنين، في حين ستغرق الدول الفقيرة في مزيد من الديون الخارجية. وسينتج عن هذا عودة قوية للهجرة من الجنوب نحو الشمال، وهي قد بدأت عمليا بكثافة لاسيما في ظل غياب مشروع مارشال دولي لمساعدة الشعوب الفقيرة.
وفي الفصل المعنون بـ “كورونا فيروس يرسم خريطة جيوسياسية للعالم” يقف على أهم التغيرات التي أصبحت ملموسة للمتتبعين والرأي العام الدولي وتلك المرتقبة. في هذا الصدد، يركز على محاور متعددة، الأول وهو نهاية العولمة في شكلها الحالي بعد إغلاق الحدود بين الدول وتراجع الاقتصاد العالمي، ووعي الدول بالعودة إلى التصنيع المحلي بعدما عانت من خصاص الكثير من المواد التي كانت تستوردها ووجدت صعوبة إبان هذا الوباء. ويشكل الوباء رصاصة الرحمة تم إطلاقها على العولمة. وهي النتيجة التي قد تكون مثار جدل إذ قد تفتح نقاشا واسعا في هذا الاتجاه.
وفي ارتباط بهذه النقطة، يبرز الكتاب أنه مقابل تراجع العولمة، هناك عودة الدولة الوطنية بفكر قومي قد يقترب من الراديكالية يعتمد المنتوج المحلي ويعتمد زرع الروح الوطنية لتحدي آثار الوباء التي ستمتد كثيرا. ويعتبر فيروس كورونا المنعطف الجديد نحو الحرب الباردة الجديدة وهذه المرة بين الولايات المتحدة والصين، وستكون حربا على المواقع الاقتصادية في العالم عكس الحرب الباردة الأولى مع الاتحاد السوفييتي التي كانت إيديولوجية عسكرية، وستعيد حدة الاستقطاب وانقسام أمم العالم.
ويتوقف الكتاب عند محور رئيسي هو ظهور رأي عام عالمي شبه موحد يتساءل عن مصير الإنسانية بعد عجز الطبقة السياسية الحاكمة عن مواجهة الوباء، نتيجة إهمال قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبحث العلمي. ويوجه دعوة إلى ضرورة استغلال هذا الوعي العالمي لصياغة “أجندة كونية” تعكس حرص الإنسانية على مصير مشترك، لكل شعوبها في تجاوز للحساسيات السياسية والثقافية والإيديولوجية.
El Houssine Majdoubi Bahida: Le monde dépend d’un masque
Éditorial Alifbooks, octobre 2020
162 pages.
Distribué par Amazon