“التحرك نحو الأعلى: لماذا تتقدم ثقافات وتتأخر أخرى”، هذا التساؤل هو عنوان كتاب من تأليف كلوتير رابيللي وأندريس رومير. ويحاول تقديم أجوبه مقنعة قائمة على أسس علمية تخص إشكالية تطور وتقدم مجتمعات دون أخرى.وقد يشكل الكتاب مرجعا للقارئ المغربي بحكم غياب نهضة علمية وثقافية واحتلال المغرب مكانة غير مشرفة في سلم التنمية البشرية وسط المنتظم الدولي، وفق مختلف التقارير ومنها تقارير منظمة الأمم المتحدة قم لاسعي للبحث عن الخروج من الأزمة أو البحث عن بديل تنموي جديد.
وتاريخيا، انصب اهتمام المؤرخين والباحثين على انهيار الحضارات وقد أبدع ابن خلدون في هذا الباب بكتابه “المقدمة”، وكتاب “سقوط الغرب” لشبنغلر. وانتقل الاهتمام خلال القرنين الأخيرين الى مستوى آخر من التعاطي مع هذا الموضوع وهو المقارنة بين الحضارات والادعاء بتفوق البعض منها على الآخر، حيث اتخذ البحث في تقدم المجتمعات والثقافات طابعا عنصريا من خلال أطروحات تقوم على تفضيل وتبجيل الاثنية والجنس والدين. وربط باحثون آخرون التقدم بالإنسان الأبيض والمناخ البارد عموما والتخلف بالإنسان غير الأبيض وبالحرارة بل أحيانا بالمسلم.
ووجه باحثون انتقادات قوية لهذا التيار الفكري وتحول الموضوع الى أشبه طابوه وسط الباحثين بسبب النظرية الخاطئة القائمة على أسس عنصرية لكنه وجد ترحيبا وسط السياسيين المتطرفين ورجال الدين. وحاول بعض الباحثين تجاوز الإشكال بترديد حضارة إنسانية واحدة ولكنها متنوعة الثقافات.
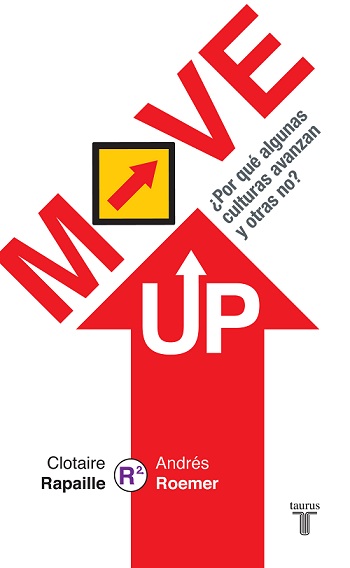
لكن الإشكال عاد للواجهة خلال العقود الأخيرة، لاسيما بعدما أصبحت المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة تهتم بتقدم الأمم وتصدر سنويا تقريرا يصنف الدول على ضوء ما تحققه من تنمية بشرية وأصبح الموضوع من الانشغالات المطروحة في الأجندة الدولية لأنه يتعلق بقضايا مثل الفقر والأمية وغياب الصحة والرفاهية. ووضعت الأمم المتحدة معايير متفق عليها دوليا لا تنطلق من مركزية ثقافية معينة مثل الغربية التي هيمنت وسادت بل من معايير شارك فيها باحثون وخبراء ينتمون الى مختلف الثقافات والديانات والمناطق الجغرافية.
ودون إهمال هذه المقاييس والمعايير، يحاول كتاب “التحرك نحو الأعلى: لماذا تتقدم ثقافات وتتأخر أخرى” الانطلاق من تصور جديد لتقدم ثقافات وتخلف أخرى باعتماد على معايير ومفاهيم أكاديمية جديدة ومنها المعايير التي يرسيها مؤلفا الكتاب أندريس رومير وهو من المكسيك دولة صاعدة تبحث عن التقدم وهو باحث من جامعة بيركلي الأمريكية وكلوتير رابيلليي وهو فرنسي من الجامعة الفرنسية العتيقة سوربون. وتلتقي نظرتان في الكتاب، نظرة الأوروبي الذي أرسى مفاهيم ونظريات في الثقافة ونظرة المكسيكي الذي ينتمي الى منطقة أمريكا اللاتينية التي ترفض مركوية الثقافة وتعيد كتاب التاريخ ومعالجة العلوم الإنسانية من زوايا جديدة.
وينتقد الكتاب التقارير الدولية التي تكتفي بتصنيف الدول تنمويا ويعتبرها جامدة لأنها لا تغوص في عمق المشكل الكامن في الأسباب الحقيقية للتخلف واستمراره بل تقف عند عملية الوصف والتصنيف. ويؤكد الكتاب أن السر في تقدم ثقافات وجمود أخرى بل واندثارها مع الوقت يعود أساسا الى الأسس الفلسفية التي تحملها هذه الثقافات بشأن كيفية ونوعية النظر الى المستقبل، حيث تتمحور أطروحة الكتاب حول ربط التقدم والازدهار بالثقافات التي تعتقد اعتقادا راسخا في قدرة الإنسان على التعمق والتغلغل أكثر في معرفة العالم من أجل التفكير والإبداع بدون ضغط وبدون قمع لتجاوز الإشكاليات الكبرى التي يواججها الإنسان. وهنا يحضر بشكل قوي مفهوم حرية التفكير وخاصة في البحث العلمي ، فالحرية ركن من أركان تقدم البشرية. وتفيد أمثلة لفهم أوسع لحرية التفكير وتقبل النظريات ومنها كيف تعاملت الشعوب مع نظريات مثل التطور عند داروين والنسبية عن إنشتاين والاستنساخ وغزو الفضاء مؤخرا.
وإذا كان الكتاب يعتبر النظام التربوي المعتمد حاسما في تقدم الأمم ومدى مطابقة هذا النظام مع نوعية المعرفة القادرة على مساهمة فعالة في تكوين الفرد ليستوعب العالم ويتحرك ويتطور، فالكتاب يؤكد على الخلل في الأطروحة السائدة لدى بعض المجتمعات في اعتبار “فضاء ثقافة معينة بقيمها ومعتقداتها هي منتهى الكون” بل يعتبر أن “فضاء وكون ثقافة معينة هو فضاء صغير ومحدود والانزواء فيه يقود الى الانغلاق والتخلف الحقيقي”.
ويفيد الواقع المعاش في صواب هذه الأطروحة، إذ تعتقد بعض الشعوب في سمو ثقافتها انطلاقا من منطلق ديني مثل “شعب الله المختار” أو “خير أمة أخرجت للناس”. وتعمد إلى الانزواء حفاظا على هويتها، ويترتب عن هذا تأخر هذه الثقافة. وتبقى الثقافة العربية منذ سقوط الأندلس حتى منتصف القرن العشرين دالة في هذا الشأن، إذ قادها التقوقع والإيمان بقيم منغلقة الى التخلف التاريخي الذي تعاني منه.
الكاتب يبرز في هذا الصدد لو كان عالم الفيزياء الشهير إنشتاين قد درس الثقافات والحضارات لكان قد انتهى الى نتيجة مفادها أن “الثقافات نسبية”، وهذا يجعل كل ثقافة جزء من فضاءات الثقافات المكونة للبشرية والإنسانية وتحتاج الى الأخرى لا لتقترب من نوع من الكمال بل لتستمر في الحياة ومقاومة التغيرات بحكم أن البقاء ليس للأقوى بل للذي يتأقلم مع التغيرات والتطورات كما يشدد على ذلك هذا الكتاب.
في الوقت ذاته، ينسب الكتاب التفاوت في الثقافات من حيث النجاح والتقدم الى مدى درجة الوعي التي يكتسبها المواطنون وأفراد الشعب وكذلك اعتماد المقارنة بين الثقافة بالحياة البويولوجية، فالحياة تسير نحو الأعلى قدما وفق مبدء التطور الطبيعي الذي لا يرتكن لمرحلة معينة. وهذا ما يحدث مع ثقافات تستمر في الصعود، وفي المقابل العكسي تبقى أخرى في مرحلة المقاومة والصمود لأنها تفتقد للمبادرة والعزيمة لتحقيق قفزة نوعية وتنتهي الى الاندثار.
هنا يستعيد مؤلفا الكتاب الأطروحة المثيرة للجدل التي تفسر التطور بالبيولوجيا، لكن هذه المرة ليس من خلال الإنسان الأبيض والأسود ومناطق البرودة والحرارة بل كيف يوظف أناس إمكانياتهم الذهنية والجسدية للتفوق عبر آلية الاجتهاد والمثابرة. ويعتمد الكتاب حالة دولة مثل سنغافورة التي انفصلت عن ماليزيا سنة 1964 ولم تكن تتوفر لا على موارد ولا على طاقات خاصة، لكن مواطني الجزيرة راهنوا على عدد من المبادرات من خلال توظيف ما هو ذهني لتتحول بلادهم الى النموذج المثالي في التقدم في أواخر القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين.
ويمتحن الكتاب مختلف الثقافات في تناولها ورؤيتها المتعددة لمفهاهيم رئيسية يقوم عليها التقدم أو كما يسميه حركية الثقافة التي تعتبر حاسمة وهي: أولا، الحرية وكيف تتعامل ثقافة في مجتمع معين مع هذا المفهوم. ثانيا، الانفتاح بمعنى مستوى درجة انفتاح ثقافة معينة على الآخرين وعدم التقوقع في “عالم واحد” والقول بالأفضلية دينيا وثقافيا. ويتجلى العنصر الثالث في الإبداع وكيف تنظر وتقيّم ثقافة ما العلوم والتطور الفردي، وأخيرا المساواة في سلم الاستحقاق اجتماعيا وإداريا بعيدا عن الولاءات. ويوظف الكتاب مفاهيم سيكولوجية في معالجة هذه العناصر لاسيما وأن كلوتير يعتبر من رواد قراءة العلوم السياسية على ضوء مفاهيم سيكولوجية.
ويعتبر هذه العناصر علاوة على الإرث التاريخي حاسمة لقياس مدى تقدم ثقافة، حيث قد يقع قصور في مفهوم من هذه المفاهيم مثل الحرية لكن الأخرى تبقى ضرورية. وهنا يستشهد بالنهضة الكبرى للصين مؤخرا في غزوها للعالم تجاريا والتي أبدعت في الانفتاح والإبداع والتركيز على الاستحقاق بدل الولاءات. كما يقارن بين ثلاث ثقافات في تعاملها مع المجتمع، الأمريكية والبرازيلية والروسية. ويرى الكتاب مستقبلا أزهى للأمريكية التي تحافظ على حركية المجتمع ثم البرازيلية التي تحررت من الكثير من القيود بينما الثقافة الروسية تنغلق على نفسها، ويسشتهد بنسبة العلماء والمفكرين الذين غادروا روسيا خلال العقدين الأخيرين.
وتبقى الأطروحة الهامة في الكتاب الذي رحبت به الأوساط الأكاديمية الغربية لإبداعه في مفهوم شرح تقدم الثقافات وربطه بالمفاهيم البيولوجية هو أن التقدم ليس اختيارا بل ضرورة للمجتمعات التي يجب أن تتجاوز الجدار الشاك وهو كيفية إرساء حركية وسطها وفي ذهنية مواطنيها وشعبها حتى لا تندثر في عالم متغير باستمرار.
وقراءة الباحث المغربي للكتاب تحيل مباشرة على تكرار العنوان وإن كان بصيغة مختلفة تعتمد على “لماذا لا تتقدم الثقافة المغربية أو العربية-الأمازيغية التي ينتمي إليها عكس ثقافات أخرى مثل الغربية والأسيوية؟” ، وقد سبق وأن عالج باحثون عرب الموضوع بكتب مثل “لماذا يتقدم الغرب ونتأخر نحن”، وذهبت الكتب أو الدراسات العربية في جلد الذات دون تقديم بديل متين أو الاحتماء عبر الدفاع عن الهوية. والكتاب يقدم آليات للباحث المغربي لمعالجة نظرة الشعب المغربي وسلطاته ومفكريه للمفاهيم الأربعة الضرورية لكل تقدم وهي: الحرية والإنفتاح والإبداع والاستحقاق الإداري-المجتمعي للوقوف على الواقع المر للتقدم/التخلف في هذا الفضاء المسمى “المغرب” أو بعابرة أكبر “العالم العربي-الأمازيغي”.







