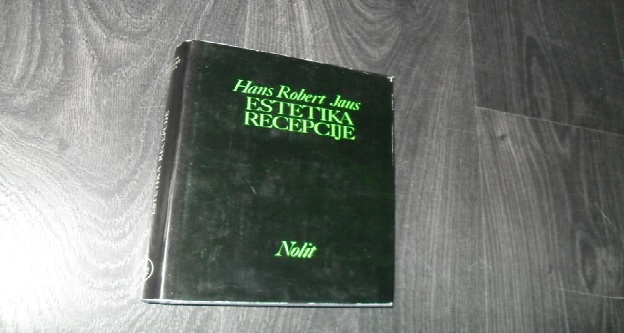بينما كانت البنيوية المتحدرة من أصول لسانية، تسيطر على أجواء باريس الثقافية في السبعينات من القرن الماضي، وكنا نسير في ركبها نحن طلاب تلك الفترة، منادين باسقلالية النص عن سيرة المؤلف، والوسط الاجتماعي الذي عاش فيه، كانت نظرية جمالية التلقي تحاول إثبات وجودها من خلال بعض الباحثين الذين وقفوا في وجه المد البنيوي ومتفرعاته، معتبرين أن هناك تعارضاً معرفياً ومنهجياً بين معرفة عقلية تستند الى منطق الأشياء في ذاتها، ومعرفة أخرى ترى أن الظواهر لا تحتوي المعاني بذاتها، بل إن الذي تنتجه الذات هو ما يبرز هذه المعاني في صورتها الكاملة. فمعنى النص لا يتشكل بذاته أبداً، ولا بد من وجود القارئ لإنتاج المعنى. ووفق هذا المنظور يكون المتلقي مكملاً للنص، لأنه يكشف عن مقاصد مبدعه، بوضعه في دائرة الضوء، وإحيائه من جديد.
ترجع أصول «جمالية التلقي» الى فلسفتين ألمانيتين هما الظاهراتية والتأويلية، وترتبط بأعلام هاتين الفلسفتين، وبخاصة هوسرل وإنغاردن اللذين جعلا من الذات القارئة، أو المتلقي ركناً أساسياً في إدراك العمل الأدبي الذي لا يتحقق عيانياً إلا بوجوده.
إذا كانت أصول جمالية التلقي تعود الى هوسرل وإنغاردن، فإن بداياتها من الناحية التطبيقية تجلت في المقترحات التي صاغها عالم الأدب الألماني هانس روبرت ياوس في دراسة نشرت عام 1970. وها هي تصدر اليوم مترجمة الى العربية بعد صدورها بما يزيد على الأربعين سنة على يد محمد مساعدي، وتنشرها دار النايا للدراسات. في هذه الدراسة التي تتناول أساسيات المعرفة الأدبية، يلفت ياوس الانتباه الى أن التردي المستمر الذي عرفه التاريخ الأدبي طيلة المئة والخمسين سنة الأخيرة، أثر سلباً على سمعته، وأفقده فعاليته وسحره، وتحول البحث العلمي حول الأدب نحو المناهج اللاتاريخية كالبنيوية والتداولية والألسنية والتحليل النفسي والسوسيولوجي. لذلك كان لا بد من تصحيح الوضع، وتبيان أن السمة المميزه للظاهرة الأدبية إنما تكمن في بعدها التاريخي.
قام ياوس تمهيداً لنشر نظريته باستعراض النظريات التي عالجت تاريخ الأدب، بدءاً من التاريخ الأدبي في شكله القليدي البدائي، الى الشكلانية والماركسية والوضعية. نظريات يتميز بعضها بفصل الجمالي عن التاريخ، بينما البعض الآخر يتميز بفصل التاريخ عن الجمالي. وفي كلتا الحالتين لا يراعى وجود القارئ، ولا يجري التنبه الى تاريخ القراءة. من هنا كانت الحاجة في نظر ياوس إلى تاريخ أدبي جديد في أسسه وتوجهاته ووسائله، يعيد الاعتبار الى المتلقي، ويكون بامكانه أن يتحدى النظرية الأدبية.
بدأ ياوس انتقاده بالمدرسة التاريخية التي تتبع التعداد الكرونولجي في سردها للوقائع والمدارس والتيارات، وكذلك في تناولها للأدباء من حيث حيواتهم وأعمالهم. من ذلك الصيغة المشهورة التي نراها في معظم الكتب التي تنتمي الى هذه المدرسة وتتمثل بالقول «حياته وأعماله». ولكن هذا النهج في نظر ياوس يقطع الاستمرارية القائمة بين الماضي والحاضر، ويعمل على انمحاء المؤرخ أمام موضوعه لكي يظهره في موضوعيته الكاملة. واتبع ياوس نقده للمدرسة التاريخية بنقده للنظرية الماركسية التي تمنح الأولوية للبنية التحتية الاجتماعية الاقتصادية، وتعتبر أن الأدب مجرد انعكاس، أو محاكاة لهذه البنية في سيرورتها التاريخية، الأمر الذي جعل النظرية الماركسية لا تؤمن باستقلالية التاريخ الأدبي عن السيرورة الاجتماعية الاقتصادية، مما أدى الى تجريد الأدب من مميزاته الخاصة، وأقفل الباب على حل المسألة التي طرحها ماركس بنفسه وتركها عالقة وهي: كيف نفسر بقاء الأعمال الأدبية واستمرارها في التأثير على مر العصور، في حين أن بنيتها التحتية الاجتماعية الاقتصادية قد تخلخلت وتلاشت؟ أما المدرسة الشكلية في نظر ياوس فركزت اهتمامها على السمة الجمالية للأدب وحدها، وعرفت العمل الأدبي تعريفاً شكلياً، ونظرت اليه باعتباره نسقاً مغلقاً، متجاهلة كل الشروط التاريخية التي يمكن أن تكون وراء نشأة العمل الأدبي وتلقيه. ولكن لم تلبث هذه المدرسة أن اكتشفت أن الأدبية التي تميز الأدب عن غير الأدب لا تتحدد تزامنياً فقط، بانزياح اللغة الجمالية عن اللغة العادية، بل وتتحدد تعاقبياً، أي تاريخياً بواسطة التعارضات الشكلية المتجددة باستمرار بين الأعمال الأدبية الجديدة، وتلك التي سبقتها في السلسلة الأدبية.
وهكذا فإن تاريخية العمل الأدبي لا تكمن فقط في وظيفته التمثيلية أو التعبيرية، بل وتكمن أيضاً في «التأثير» الذي يمارسه. ومن هنا يستخلص ياوس نتيجتين مهمتين لتأسيس التاريخ الأدبي على قواعد جديدة، أولها أن حياة العمل الأدبي لا تنجم عن وجوده في حد ذاته، بل عن التفاعل الذي يتم بينه وبين القراء، أي بين الذات المنتجة والذات المستهلكة، أو في كلام آخر بين الإنتاج والتلقي. وثانيها أن الوظيفة الثورية والدور الفعال اللذين يؤديهما الشكل الأدبي لا يمكن الإمساك بهما أبداً، إذا نظرنا الى هذا الشكل كمحاكاة بسيطة، وإنما كسمة جدلية قائمة بين العمل الأدبي ومتلقيه.
اقترح ياوس بناء على انتقاداته للنظريات النقدية السابقة دراسة العمل الأدبي عبر تاريخ التلقي. وهذا يعني أنه ينبغي دراسة الأعمال الأدبية من خلال تلقي القراء لها، فطرح مجموعة من المفاهيم من بينها «أفق الانتظار» الذي يتضمن ثلاثة مبادئ أساسية. أولاً التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور من الجنس الذي ينتمي اليه النص، ثانياً شكل الأعمال السابقة وموضوعاته التي يفترض معرفتها، وثالثها التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العملية اليومية، أي التعارض بين العلم التخييلي والواقع اليومي.
يُفهم من هذا الكلام، تركيز ياوس على معرفة القارئ المسبقة لمجموعة من التقاليد والأعراف التي تميز الأجناس الأدبية بعضها عن بعض. هذا التمييز الذي لا يمكن أن يكون إلا بالممارسة التي تمكن القارئ من معرفة التشويشات التي تصيب التقاليد والأعراف الفنية بين حين وآخر. فحين يشرع المتلقي في قراءة عمل أدبي حديث الصدور، فإنه ينتظر منه أن يستجيب لأفق انتظاره، أي أن ينسجم مع المعايير الجمالية التي تكون تصوره الخالص للأدب، في حين يسعى المؤلف في الغالب الى انتهاك هذه المعايير ومخالفتها، مما يجعل طريقته في الكتابة تدخل في صراع مع أفق انتظار هذا المتلقي. ويسمى هذا الفارق بين كتابة المؤلف، وأفق انتظار القارئ بالمسافة الجمالية. والمسافة الجمالية وفق ياوس هي البعد القائم بين ظهور الأثر الأدبي نفسه، وأفق انتظاره.
ويمكن الحصول على هذه المسافة من خلال استقراء ردود أفعال القراء على الأثر، أي من خلال تلك الأحكام النقدية التي يطلقونها. فكلما زادت درجة تراجع هذه المسافة، ازداد اقتراب العمل الأدبي من محيط الفن «المطبوخ» أو «الترفيهي»، أي من تلك الأعمال التي ترضي، وتلبي آفاق انتظار الجمهور، ولكن لا تلبث أن تخضع للانحسار والجمود. أما الأعمال الأدبية الجيدة، فهي التي تخيب آفاق الانتظار لدى جمهورها وتغيظه، ومن ثم فهي تطوره وتطور وسائل التقويم والحاجة إلى الفن.
أراد ياوس أن يفهم الأدب والتاريخ الأدبي من خلال فكرة التطور، محاولاً أن يستفيد مما قدمه الفيلسوف الألماني غادامر في حديثه عن الوعي التاريخي الذي يتشكل باللغة عند جمهور القراء، ولذلك كان يرى بأن التاريخ تجربة نعانيها، وتقليد ليس من السهل الخلاص منه. في فهمنا لتلقي الأدب، وإدراك جماليته.
كتاب ياوس «نحو جمالية للتلقي» محاولة لتخليص الأدب من الأزمة التي كان يتخبط فيها تحت الجبرية المذهبية لتقاليد ماركس والشكلانية الروسية والبنيوية، ومسعى يعيد التفكير في الأعمال الأدبية، وفي كيفية تأثرها بالسياق التاريخي، وبالظروف والأحداث الجارية، ومدى تأثرها، وتأثيرها فيها.